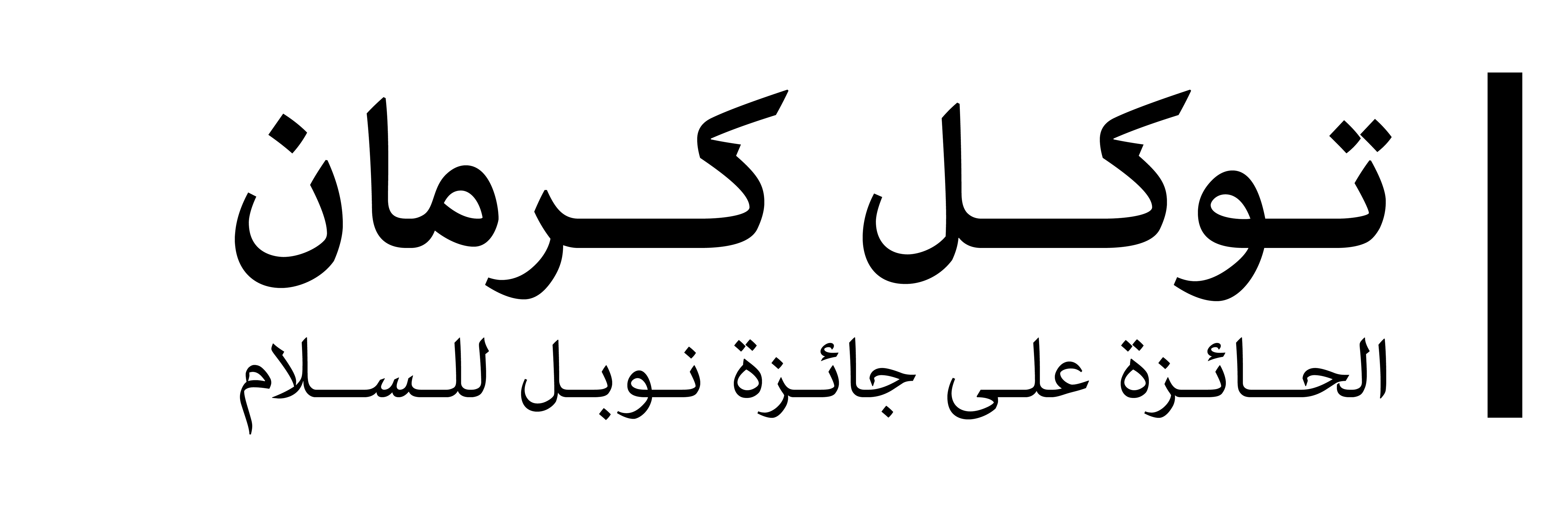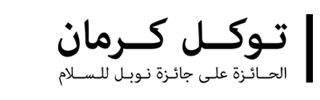كلمات

محاضرة توكل كرمان في جامعة أكسفورد بعنوان: من تآكل وتفكك الدولة الوطنية إلى تصدّع النظام العالمي
مرحبًا بالجميع،
أشكر جامعة أكسفورد واتحاد طلابها على دعوتي للقاء بطلبتها مرة أخرى، ولمناقشة جملة من القضايا المصيرية التي يمر بها عالمنا اليوم.
نلتقي اليوم في لحظة تاريخية لا يمكن توصيفها بوصفها أزمات متفرقة، بل كإعادة تشكّل كبرى تتآكل فيها المفاهيم والبُنى التي قامت عليها الدولة الوطنية، ويتصدّع النظام العالمي، ويتمزّق النسيج الاجتماعي، وتتراجع القيم الإنسانية التي ظنّ العالم بعد منتصف القرن العشرين أنها أصبحت راسخة في منجز الحضارة. وهذا التآكل مترابط؛ فحين تضعف الدولة تتآكل المجتمعات، وحين يتراجع النظام الدولي عن حماية القانون يسود منطق القوة، وحين تُهمَّش القيم يصبح الاستبداد والاحتلال والقمع، بل حتى الإبادة، قابلة للتبرير.
ودعونا نبدأ بالحديث عن تآكل الدولة الوطنية:
ينشأ تآكل الدولة حين يتقاطع الاستبداد الداخلي مع التدخل الخارجي. فالاستبداد لا يدمّر السياسة وحدها، بل يفرّغ الدولة من معناها، ويحوّلها من إطار جامع للمجتمع إلى أداة للسيطرة عليه. والدولة الحديثة، في أصل فكرتها، ليست جهاز قمع، بل فكرة أخلاقية وسياسية تقوم على عقدٍ اجتماعي تُمنَح بموجبه السلطة مقابل الأمن، والحقوق، والعدالة. وتستمد شرعيتها من سيادة القانون، واستقلال المؤسسات، والمواطنة المتساوية، والإرادة الشعبية، ضمن هوية وطنية تحمي الكرامة الإنسانية.
لكن هذه الفكرة تآكلت على نطاق واسع. فقد تحوّلت الدولة في كثير من بلداننا من ممثّلٍ للمجتمع إلى وصيٍّ عليه، ومن ضامنٍ للحقوق إلى محتكرٍ للقوة. ولم يعد الاستبداد استثناءً عابرًا، بل أصبح نمط حكم راسخًا يعيد إنتاج نفسه داخل النظام الدولي المعاصر. واستبدال العقد الاجتماعي بشبكات الولاء والخوف والفساد أدّى إلى تفكيك الدولة من الداخل: جيوش مرتبطة بالحاكم لا بالدستور، وقضاء منزوع الاستقلال، واقتصاد يُدار بالمحسوبية لا بالسياسات العامة.
وهكذا نشأت ما يمكن تسميته «الدولة الهشّة المقنّعة»: دولة تبدو مستقرة في ظاهرها، لكنها متآكلة في جوهرها. وعندما ينهار الغطاء الاستبدادي، لا يحدث انتقال مؤسسي طبيعي، بل ينكشف الفراغ، فتتقدّم الميليشيات، والهويات المسلّحة، والولاءات ما دون الوطنية. وهذا ما يفسّر لماذا انهارت دولٌ عدّة، ومنها دول شهدت الربيع العربي، بهذه السرعة فور سقوط أنظمتها المستبدة.
غير أنّ الاستبداد وحده لا يفسّر تفكك الدول. فعندما تُنهَك الدولة من الداخل بفعل الاستبداد، تتحوّل إلى ساحة مفتوحة للتدخل الخارجي. عندها تتدخل قوى إقليمية ودولية، لا لإعادة بناء الدولة، بل لاستثمار ضعفها وإدارته، عبر سياسات تُغلَّف بعناوين الأمن، ومكافحة الإرهاب، وإدارة الأزمات، وتُستخدم فيها أدوات الضغط الاقتصادي، والديون، والعقوبات، ودعم القوى الوكيلة.
وحين يسقط الحاكم بفعل مطالب التغيير والثورات الشعبية—وكان في الغالب أداتها الأولى—تسارع هذه القوى إلى الاستثمار في الفوضى، وخلق كيانات موازية للدولة، ودعم الميليشيات، وتطبيعها تحت شعار «الواقعية السياسية». والنتيجة هي الإبقاء المتعمّد على الدول في حالة «لا حرب، لا سلام، لا دولة»، ضمن عملية تدريجية محسوبة يُفرَّغ فيها كيان الدولة من مضمونه دون إسقاطه رسميًا، ليُقدَّم التفكيك والتقسيم لاحقًا بوصفهما الخيار «الواقعي» الوحيد، بما يُجهض أي تحوّل ديمقراطي حقيقي.
وكل ذلك بهدف ضمان استمرار الهيمنة والنفوذ—المباشر وغير المباشر—على الجغرافيا والموارد والثروات.
فهذا ما جرى بالفعل خلال الربيع العربي. فقد شكّلت ثورات الربيع العربي عام 2011 محاولة تاريخية لاستعادة الدولة من الاستبداد والفساد والتبعية. ولم تكن تلك الثورات فعل فوضى أو تدمير، بل كانت ثورات ضد اختزال الدولة في الحاكم وشبكته الضيقة من المصالح. غير أنّ هذه الحركات اصطدمت ببيئة إقليمية ودولية معادية؛ إذ رأت قوى إقليمية وعالمية تخشى الديمقراطية في أي انتقال ديمقراطي ناجح، وفي قيام دول قوية قائمة على المؤسسات وحكم القانون، تهديدًا وجوديًا لها، فسعت بوعي ومنهجية إلى إفشاله.
وفي هذا السياق، تبرز دولة سخّرت فائضًا هائلًا من الثروة في مشروع منظّم لتفكيك الدول الوطنية، وهي دولة الإمارات العربية المتحدة. فمن السودان إلى ليبيا، ومن الصومال إلى اليمن، تتجلّى سياسة تقوم على دعم الميليشيات، وتمزيق النسيج الاجتماعي، وإعادة هندسة الصراعات بما يمنع أي فرصة للاستقرار أو قيام دول مدنية مستقلة. هذه ليست سياسات نفوذ تقليدية، بل مشروع هدم للدولة الوطنية الحديثة، لا ينتج أمنًا ولا نظامًا، بل يعيد إنتاج الفوضى كأداة للسيطرة.
وينطبق هذا التوصيف بالقدر ذاته على نظام الملالي في طهران، الذي يقوم بدوره على تقويض الدول، وتأجيج الصراعات، وتوظيف الهويات الطائفية كسلاح سياسي عابر للحدود. وهاتان القوتان تمثلان معًا خطرًا جسيمًا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
في اليمن، وبعد نجاح ثورة 11 فبراير السلمية وإطلاق مرحلة انتقالية واعدة وحوار وطني شامل، تعرّض المسار لهجوم منظم بدعم إيراني لميليشيا الحوثي المتحالفة مع علي عبد الله صالح، ما قاد إلى انقلاب سبتمبر 2014. ومع تمدد الانقلاب، أُطلق التحالف السعودي–الإماراتي عام 2015 تحت شعار استعادة الشرعية، لكن الحرب لم تحقق هذا الهدف، بل جرى العكس تقويض الشرعية ومصادرة القرار الوطني والعمل على تفكيك الدولة.
وبرز الدور الإماراتي خصوصًا عبر استراتيجية قائمة على تفكيك الجغرافيا والنسيج الاجتماعي، وإنشاء وتمويل قوى مسلحة خارج سلطة الحكومة، تحولت إلى بدائل فعلية لمؤسسات الدولة، إلى جانب السيطرة على الجزر والموانئ والسواحل. والمفارقة أن هذا النهج لم يواجه الحوثيين كتهديد وجودي، بل أسهم عمليًا في تثبيتهم، عبر إنهاك الشرعية وترك الحوثيين يرسخون سلطتهم في الشمال ويظهرون كمدافعين عن سيادة اليمن.
في السودان، يظهر هذا النمط بأوضح صوره وأكثرها دموية. فبعد ثورة فتحت أفقًا حقيقيًا لبناء دولة مدنية، جرى تمكين ميليشيا الدعم السريع كقوة موازية للدولة لا ضمن مسار دمج مؤسسي، بدعم سياسي ومالي وعسكري مقصود، انطلاقًا من منطق يرى في الميليشيا أداة نفوذ أقل كلفة من الدولة. فتحولت إلى لاعب ينازع الدولة سلطتها، ومع انفجار الصراع لم يكن الفشل فشل الثورة وحدها، بل فشل نهج إقليمي يستبدل الدولة بالتفكيك، فيما تعكس الجرائم المرتكبة منطق السلاح بلا شرعية وتدخلًا خارجيًا حوّل انهيار الدولة إلى مشروع نفوذ يُدار من الخارج.
ولا يختلف المشهد كثيرًا في ليبيا؛ إذ لم تُمنح الدولة فرصة لإعادة بناء مؤسساتها بعد سقوط النظام، بل جرى تدويل الفراغ عبر تعدد الرعاة والميليشيات والأجندات الخارجية، فأصبح غياب الدولة هو القاعدة، وتحولت ليبيا إلى ساحة صراع دائم بلا أفق سياسي مستقر.
وفي الصومال، يتكرّس المسار ذاته عبر شرعنة الانقسام بدل معالجة فشل الدولة، كما في الاعتراف بجمهورية أرض الصومال، بما يكرّس التفكك ويفتح ثغرة استراتيجية خطيرة في القرن الإفريقي. وهنا، مرة أخرى، لا يدور الصراع بين دول، بل بين منطق يرى في الدولة الوطنية إطارًا لا غنى عنه، ومنطق يرى في تفكيكها فرصة استراتيجية للنفوذ.
هذا التوجه يلتقي موضوعيًا مع مشاريع التفتيت الإقليمي، حتى وإن اختلفت الخطابات. فحين تتقاطع مصالح قوى إقليمية تسعى للنفوذ عبر الميليشيات، مع رؤية إسرائيلية تستفيد من ضعف الدول، ومع نظام دولي متراخٍ في حماية السيادة، يصبح تفكيك الدولة خيارًا ممكنًا، بل مغريًا.
تجارب عديدة في عالمنا تقدم درسًا قاسيًا: التقسيم، سواء أُعلن رسميًا أم فُرض كأمر واقع، لم ينهِ الصراع، بل أعاد إنتاجه بأشكال أكثر تعقيدًا. الكيانات الناتجة عن التفكيك لا تكون مستقرة ولا ديمقراطية، بل تعتمد على الحماية الخارجية وتعيش في حالة توتر دائم.
اليمن المفكَّك ليس خطرًا على المجتمع اليمني وحده، بل تهديد مباشر لأمن البحر الأحمر، وامن السعودية وأمن الخليج والامن العربي برمته ،، وممرّات الطاقة العالمية.
الوحدة اليمنية ليست شعارًا أيديولوجيًا، بل شرطًا أساسيًا لاستقرار اليمن والسعودية والخليج والمنطقة والعالم. اليمن المفكَّك ليس خطرًا على المجتمع اليمني وحده، بل تهديد مباشر لأمن البحر الأحمر، وممرّات الطاقة العالمية، وبدونها لن يكون هناك استقرار طويل الأمد، ولا أمنٍ وسِلمٍ إقليمي أو عالمي.
الصومال المقسّم لا يهدد القرن الإفريقي فقط، بل يفتح ثغرة استراتيجية تمتد آثارها إلى الخليج أيضا.
السودان المنهار يشكّل اختلالًا مباشرًا في الأمن القومي المصري، ويعيد إنتاج عدم الاستقرار في عمق العالمين العربي والإفريقي.
وهكذا يتكرّر الصدام بين مشروع بناء الدولة ومشروع تفكيكها في أكثر من ساحة عربية وإفريقية، بما يؤكّد أننا لا نواجه أزمات محلية منفصلة، بل نمطًا إقليميًا متكاملًا لإدارة النفوذ عبر إضعاف الدولة الوطنية وتقويضها. وقد أثبت هذا المسار أنه لا يقود إلى الاستقرار ولا يفتح أي أفق حقيقي لحلّ الصراعات، بل يدفع نحو تدويلها، ويحوّلها إلى تهديد مباشر للإقليم وللأمن والسِّلم العالميين، كما يتجلّى بوضوح في اليمن والصومال والسودان.
في المقابل، يظلّ مسار الحفاظ على وحدة الدول وبنائها الإطار الوحيد الممكن لمستقبل تتّسع فيه الحياة، ويسود فيه الأمن والاستقرار، وتُفتح فيه آفاق التنمية، وتتحقّق تطلعات المجتمعات واحتياجاتها الأساسية من الغذاء، والتعليم، والصحة، والعمل، والعيش الكريم.
والأخطر أن نجاح تفكيك الدولة في بلدٍ واحد يخلق سابقة قابلة للتعميم، ويجعل أي دولة أخرى عرضة للمصير ذاته عند تبدّل المصالح. ومن هذا المنطلق، لا يُفهم دفاع السعودية ومصر وتركيا عن الدولة الوطنية بوصفه تضامنًا سياسيًا عابرًا، بل إدراكًا استراتيجيًا بأن انهيار الدولة في المحيط الإقليمي سيقود إلى زعزعة شاملة تهدّد الجميع، لأن الدولة—رغم عيوبها—تبقى الإطار الوحيد القادر على ضبط العنف، وتنظيم المصالح، ومنع تحوّل الجغرافيا إلى فراغٍ مفتوح.
ولهذا، فإن مسؤولية المجتمع الدولي لا تنبع من التعاطف مع منطقتنا فحسب، بل من إدراك مصالحه هو. فالفوضى في هذه المنطقة، بما تمثّله من عمقٍ جغرافي، وممرّات بحرية حيوية، وثقلٍ سياسي، تشكّل تهديدًا مباشرًا للاستقرار العالمي ذاته. وما لم يُواجَه مشروع تفكيك الدول بوضوح وحزم، فإن النظام الدولي برمّته سيظلّ مهدّدًا بسياسات الفوضى العابرة للحدود.
____
أيها الأعزاء ..
لا يمكن فصل ما نشهده من تفكك للدول عن التصدّع الأوسع الذي يضرب النظام العالمي نفسه. فتراجع الديمقراطية، وتجاوز القانون الدولي، وازدواجية المعايير، وعودة النزعات التوسعية، كلها أسهمت في ترسيخ منطق إدارة العالم بالقوة لا بالقانون. ولم يعد تجاهل سيادة الدول الضعيفة استثناءً عابرًا، بل أصبح جزءًا من مشهد عالمي يتآكل فيه الالتزام بالمبادئ التي تأسس عليها النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية.
ما نواجهه اليوم ليس مجرد خلل في موازين القوى، بل أزمة شرعية أخلاقية عميقة. فالنظام الدولي، الذي قام نظريًا على القانون والمؤسسات والمسؤولية الجماعية، تحوّل عمليًا إلى منظومة انتقائية تُفعَّل فيها القواعد حين تخدم الأقوياء، وتُعطَّل حين يكون الضحايا شعوبًا ضعيفة. وحين تصبح الازدواجية بنية دائمة، تفقد القواعد معناها، وتفقد المؤسسات قدرتها على الردع والإقناع.
وقد شكّل الغزو الروسي لأوكرانيا لحظة فاصلة في هذا المسار، إذ كسر أحد المحرّمات الكبرى في النظام الدولي عبر استخدام القوة العسكرية لفرض واقع جغرافي جديد، في انتهاك صريح لمبدأ سيادة الدول ووحدة أراضيها. لم يكن ذلك نزاعًا إقليميًا عابرًا، بل اختبارًا جوهريًا لقدرة النظام الدولي على الدفاع عن قواعده.
غير أن هذا الانهيار بلغ ذروته الفاضحة في غزة، حيث جرت مجازر واسعة وتدمير منهجي للمدن واستهداف مباشر للمدنيين والبنية التحتية، وسط صمت دولي وتواطؤ سياسي واستخدام للفيتو وفّر الغطاء للجريمة. هنا لم يُعطَّل القانون الدولي فحسب، بل جرى تفريغه من مضمونه، وتحويل مفاهيم مثل “الدفاع عن النفس” إلى أدوات لتبرير القتل الجماعي، فيما يُجرَّم الضحايا حين يطالبون بحقهم في الحياة.
ولم تكن غزة استثناءً. فقد سبقتها محطتان تأسيسيتان لهذا الانهيار: العراق وأفغانستان. دول دُمّرت بذَرائع ثبت بطلانها، من دون مساءلة حقيقية، لترسّخ رسالة خطيرة مفادها أن القوة قادرة على التدمير بلا حساب، وعاجزة عن بناء دولة أو سلام مستدام.
وفي أمريكا اللاتينية، ، حين استُخدم خطاب “الديمقراطية” و“مكافحة المخدرات” غطاءً لاختطاف رئيس الدولة ومصادرة القرار السيادي ونهب الموارد، كما في فنزويلا. نعم، النظام هناك استبدادي ومادوروا ديكتاتور قتل وشرد شعبه ، ونحن نساند الشعب الفنزويلي في نضاله من أجل الحرية، لكن هذا الامر لا يبرر ابداً اختطاف الولايات المتحدة الامريكيه له ، بدون أي قواعد قانون دولي ، هذا الدور منوط بمؤسسات العدالة المحلية او الدولية وليس دور دونالد ترمب ، الاستبداد لا يُهزم بالقرصنة، ولا تُبنى الديمقراطية على اختطاف إرادة الشعوب أو بمنطق عصابات المافيا.
في هذا السياق، لا تكمن الخطورة فقط تآكل النظام الدولي ، بل في الدعوات إلى هدم النظام الدولي نفسه بدل إصلاحه، كما تجلّى في نهج إدارة ترامب في ما سُمّي “مجلس السلام العالمي”، والسعي إلى تقويض الأمم المتحدة والعمل متعدد الأطراف، وازدراء القانون الدولي، وتكريس منطق الصفقات والقوة بوصفه “واقعية جديدة”. لم يكن ذلك إصلاحًا، بل تفكيكًا لما تبقى من قواعد مشتركة.
إن تفكيك النظام العالمي ليس حلًا، بل وصفة لعالم تحكمه القوة العارية، حيث تُقرَّر مصائر الشعوب بميزان السلاح لا بميزان الحق. المطلوب ليس الهدم، بل إصلاح جذري يعيد الاعتبار للقانون الدولي كقاعدة ملزمة للجميع، ويصلح مؤسسات الحوكمة العالمية، وفي مقدمتها مجلس الأمن، وينهي امتيازات النقض التي عطّلت العدالة، ويخضع الشركات الكبرى للمساءلة، ويعيد تعريف السلام بوصفه ثمرة للعدالة لا صفقة تُفرض بالقوة.
___
أخيراً أيها الأعزاء :
لا يقتصر التصدّع الذي يعيشه عالمنا اليوم على الدولة الوطنية أو النظام الدولي، بل يمتدّ إلى المجتمعات نفسها، حيث يتمزّق النسيج الاجتماعي وتتآكل الروابط التي قامت عليها الثقة والتعايش. ففي ظل الحروب والاستبداد واللامساواة والخطابات الإقصائية، تتراجع فكرة المجتمع بوصفه شراكة إنسانية جامعة، وتعلو الهويات الضيقة، ويتحوّل الاختلاف من مصدر غنى إلى أداة صراع وكراهية.
في الحالة العربية، جرى تحويل التنوع الديني والمذهبي—سني وشيعي، مسلم ومسيحي، يهودي ودرزي، عربي وكردي— من مصدر غنى إلى وقود للانقسام والعنف ، رغم أن المعركة الحقيقية في منطقتنا لم تكن يومًا بين هذه الهويات، بل بين الحرية والاستبداد. غير أن المستبد من جهة ، والمستعمر من جهة أخرى ، و قوى إقليمية وكبرى أخرى ، عملوا على استخدام هذه الهويات غير الوطنية كأدوات صراع سياسي، تُحرَّك لتفكيك المجتمع وضرب وحدته ، وحرفه عن معركته الأساسية من اجل الحرية والعدالة والكرامة والمواطنة المتساوية وحكم القانون .
أما في الحالة الغربية، فيتجلى التمزق في تصاعد الانقسامات العرقية، وكراهية اللاجئين والأجانب، وتنامي الإسلاموفوبيا ، بالتوازي مع استقطاب حاد بين أقصى اليمين وأقصى اليسار. هذا الاستقطاب لا يضعف النسيج الاجتماعي فحسب، بل يُقوّض الديمقراطية نفسها، ويدفعها إلى التآكل والتراجع، ومعها تضعف الدولة. وهذا بالضبط ما يريده حلف المستبدين في العالم: مجتمعات منقسمة من الداخل، يسهل اختراقها، وتفقد قدرتها على الدفاع عن قيمها وأنظمتها الديمقراطية، وتجعل من مجتمعاتكم هشه، وأكثر قابلية للانزلاق نحو العنف والاستبداد.
ويكتمل هذا المشهد القاتم مع الفجوة الاقتصادية العالمية المتسعة. يعيش العالم اليوم واحدة من أعمق حالات اللامساواة في تاريخه الحديث. ثروات هائلة تتكدس في أيدي قلة عابرة للحدود، بينما تُدفع شعوب بأكملها إلى الفقر والهشاشة وانعدام الأمن الغذائي.
هذه الفجوة ليست خللًا عرضيًا، بل نتيجة مباشرة لنظام اقتصادي عالمي صُمم ليخدم رأس المال أكثر مما يخدم الإنسان. وفي قلب هذا النظام تقف الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، التي لم تعد فاعلًا اقتصاديًا فقط، بل تحولت إلى قوة سياسية غير منتخبة، تضغط على الحكومات، وتستفيد من النزاعات، وتعمل على تفكيك المجتمعات وتشارك في تفريغ القوانين البيئية والاجتماعية من مضمونها.
____
السؤال الملح الان أمام كل هذا التدهور والتفكك على مستوى كثير من الدول الوطنية والنظام العالمي برمته ما العمل ؟
المطلوب منّا اليوم ليس اليأس، بل التمسّك بالأمل. ما يحتاجه هذا الزمن هو الشجاعة: شجاعةٌ أخلاقية تُسمّي الأشياء بأسمائها، وتقول الحقيقة دون خوف من أحد؛ وشجاعةٌ سياسية، بلا مواربة، تواجه الاستبداد والاحتلال وكل محاولات تفكيك الدول وتمزيق الشعوب؛ وشجاعةٌ فكرية ترفض تزوير نضال الشعوب وتبرير الانهيار أو التكيّف معه.
أولًا، لا بد من الدفاع عن الدولة والديمقراطية معًا، ومقاومة الاستبداد حيثما وُجد، فالدولة ليست نقيض الحرية، بل شرطها حين تُبنى على المواطنة المتساوية، وسيادة القانون، واستقلال المؤسسات. علينا أن نرفض الثنائية الزائفة بين الاستبداد والفوضى، وبين الدولة والحرية. فالدولة القوية قادرة—وملزمة—بحماية الحقوق لا بمصادرتها.
وهذا يفرض على المجتمعات الديمقراطية مسؤولية مزدوجة: حماية ديمقراطياتها من الداخل. فالديمقراطية ليست إرثًا مضمونًا، بل ممارسة يومية ونضالًا متواصلًا—ضد هيمنة المال على السياسة، وضد جماعات الضغط غير الخاضعة للمساءلة، وضد اختطاف المؤسسات، وضد اختزال السياسة إلى سوق، والانتخابات إلى طقوس خاوية.
ثانياً، يجب إعادة الاعتبار للقانون الدولي بوصفه قانونًا مُلزِمًا لا خطابًا انتقائيًا. لا سيادة تُحترم بالانتقاء، ولا جرائم تُعاقَب بالانتقاء. الإبادة الجماعية، والاحتلال، والقتل الجماعي جرائم يجب مواجهتها أيًّا كان مرتكبوها وأيًّا كان من يحميهم. فالإفلات من العقاب ليس حيادًا؛ بل تواطؤ.
ثالثاً، لا يجوز التعامل مع تفكيك النظام الدولي كحل. نعم، النظام القائم معيب، وظالم، وانتقائي، لكن انهياره الكامل سيُطلق عالمًا بلا قواعد، تحكمه القوة المجردة، وتُحدَّد فيه المصائر بالسلاح لا بالحقوق. مهمتنا ليست الهدم، بل الإصلاح الجذري: قانون دولي يُطبَّق على الجميع دون استثناء، ومؤسسات عالمية خاضعة للمساءلة، ومجلس أمن لا يُسمح له بشلّ العدالة باسم حق النقض.
رابعاً يجب رفض سياسات التفتيت—الطائفية والعرقية والعنصرية والأيديولوجية. فمعركتنا الحقيقية ليست بين الهويات، بل بين الحرية والاستبداد، وبين المواطنة والهيمنة. المجتمعات لا تُصان بإلغاء الاختلاف، بل بتنظيمه داخل إطار سياسي وأخلاقي مشترك.
خامساً : حاسِبوا حكوماتكم وشركاتكم على ما تفعلانه باسمكم، وبأموالكم، وبقوتكم السياسية والاقتصادية. لا تمنحوهم شيكًا على بياض لتمويل الحروب، أو دعم الاستبداد، أو تفكيك الدول وتقسيمها ، أو تحقيق الأرباح من الفوضى. فالمساءلة؛ إنها جوهر الديمقراطية. حين تُترك السلطة بلا رقابة تتحوّل إلى خطر، وحين تُكمَّم القيم يُفتح الباب أمام الجريمة. كما لا يمكن بناء عالم عادل بينما تتحكم شركات عابرة للحدود في الاقتصاد، والمعرفة، والفضاء العام دون أي مساءلة ديمقراطية. العدالة الاجتماعية، وحماية البيئة، وضبط شركات التكنولوجيا، ليست قضايا ثانوية، بل جوهر معركة المستقبل.
وأخيرًا، أقول لكم بوضوح: الرهان عليكم أنتم الشباب ، طلبة الجامعة ، اساتذه الجامعات ، المفكرين والادباء والفناينين ،رواد الفكر والمعرفة والابداع
التاريخ تغير لأن أجيالًا من الطلاب والمفكرين والشباب رفضت أن تعيش بلا معنى، وبلا كرامة. لا تنتظروا الإذن لتكونوا أخلاقيين، ولا تنتظروا الإجماع لتقولوا الحقيقة.
أنا أثق بالشعوب. وأراهن عليها. وأثق، أكثر من أي وقت مضى، بجيل الشباب.
أراهم اليوم في شوارع العالم، في مظاهرات عابرة للحدود، يرفعون الصوت ضد الحروب، وضد الإبادة، وضد الظلم، وضد نفاق أنظمتهم. أراهم يربطون بين فلسطين، وأوكرانيا، والسودان، واليمن، والمناخ، والعدالة الاجتماعية، لأنهم فهموا ما تحاول السلطة تفكيكه: أن كل هذه القضايا متصلة، وأن الظلم واحد مهما اختلفت الجغرافيا.
هذا الجيل لايقبل أن يُقال له إن الواقع لا يمكن تغييره، لأن التاريخ علّمه أن الواقع يتغير حين تُجبره الشعوب على ذلك.
التاريخ لم يُغلق صفحته بعد ـ والكلمة الأخيرة لم تُقَل بعد.
الشعوب، لا الطغاة، ولا الإمبراطوريات، ولا تجّار الحروب، هي من ستكتب الخاتمة.
قد يكون الطريق طويلًا، وقد يكون الثمن فادحًا، لكن لا حرية بلا ثمن، ولا عدالة بلا تضحيات. وما يبدو اليوم مستحيلًا، يصبح غدًا بديهيًا حين تصرّ الشعوب على حقها في الحياة والكرامة.
أنا أؤمن بذلك ، وأدعوكم أن تؤمنوا به معي… وأن تكونوا جزءًا من كتابته، لا مجرّد شهود عليه.
شكراً لكم.